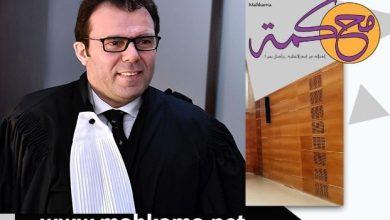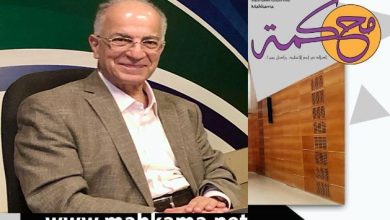عقوبة الإعدام/جوزف سماحة

القاضي الدكتور جوزف سماحة*:
الجريمة ظاهرة ثابتة في كل المجتمعات البشرية و في كل الدول مهما اختلفت أنظمة الحكم فيها. و قد تعدّدت محاولات تعريف الجريمة، بيد أن التعريف الأكمل هو الذي اقترحه العلامة الفرنسي “رينيه غارّو” وهو أن الجريمة هي كل فعل أو امتناع لحظه نص قانوني وأفرد له عقوبة جزائيّة ولا يكون مبرّراً بممارسة حق أو بأداء موجب.
كل فعل مقصود، أو سلوك جرمي بصورة عامة، يشكّل تهديدا للمجتمع، عندما يخلّ بالقواعد الأساسيّة التي كرّسها لضمان أمنه و سلامته و استقراره. كما يتسبب في إلحاق الضرر في المصالح العامة و يطال حقوق الأفراد المجني عليهم، ما يستدعي التصدي للمعتدي من أجل حماية تلك الحقوق و ضبط الأمن، بواسطة القوانين التي تجرّم تلك الأفعال و تحدّد لها جزاء، وتنظّم أصول التحقيق و الملاحقة.
وتتوخّى القوانين ذات الطابع الجزائي (سواء كانت تتعلّق بالعقوبات أم بأصول المحاكمات الجزائية) حماية المصالحة الحيويّة والمشروعة في المجتمع، على الصعيدين العام و الفردي، من أجل توفير الطمأنينة و الاستقرار و الحماية للأفراد، و لإرضاء النزعة الدفينة لدى كل امرئ الى تحقيق العدالة وإحقاق الحق.
وتتحقق هذه الأهداف في الملاحقة الجزائيّة، التي تتولاّها بصورة أساسية النيابات العامة باسم المجتمع فتحرّك دعوى الحق العام عندما تتوافر لديها، بنتيجة التحقيقات الأولية التي تجريها وتشرف عليها، شبهة جديّة و كافية على وقوع جريمة و/أو معرفة هوية كل من لعب دورا فيها… وتتابع النيابات العامة الدعوى العامة، سواء خلال مرحلة التحقيق الابتدائي متى أحيلت القضية أمام قضاء التحقيق… أو أمام قضاء الحكم (إما على أثر ادعاء مباشر أمام القاضي المنفرد الجزائي في الجرائم من نوع الجنحة و المخالفة، أو بنتيجة صدور قرار ظني أو قرار اتهام عند انتهاء التحقيق الابتدائي …) حتى تحديد و ثبوت العناصر الجرمية وتبيان الأشخاص المسؤولين عن الجريمة، عندما تتكوّن أدلّة كافية على هذه المسؤوليّة، فيصدر القضاء المختص حكمه بالإدانة… أو بالتجريم… و يلفظ العقوبة الملائمة في حق المحكوم عليه.
وتعتبر العقوبة الغاية النهائيّة للملاحقة الجزائيّة، و هي تؤلّف وسيلة لبلوغ أهداف عدّة تتمحور في العلم الجزائي المعاصر حول أمور ثلاثة:
1- ردع المجرم لمجازاته و إحباط مشروعه الإجرامي، أو نتائجه، و ثنيه عن غيّه، و هو ما يعرف بالردع الخاص… إلى جانب جعله عبرة للغير ممن قد تسوّل لهم أنفسهم الإقدام على أفعال جرميّة مشابهة، إذ يمكن ان تؤلف الجريمة المقترفة تشجيعاً لهم، و تشديداً لعزيمتهم على الانحراف نحو الإجرام، و هذا ما يعرف بالرّدع العام .
2- إنزال قصاص عادل بالمجرم موازٍ لخطورة الجريمة و لجسامة الضرر الناتج عنها، بحيث يُفضي ذلك الى جعله يكفّر عن الذنب الذي اقترفه في حق المجتمع و المجني عليهم من أفراده المتضرّرين في أرواحهم، أو سلامتهم البدنية، أو سمعتهم وكرامتهم، أو في ممتلكاتهم.
3- السعي الى إعادة تأهيل المجرم و إصلاحه ليتمكّن، بعد تنفيذ عقوبته، من العودة الى الاندماج في المجتمع كعنصر عادي فاعل و منتج فيه، يتأقلم مع النظم والقوانين التي ترعى شؤونه؛ و هذا الهدف يضفي على القصاص (أو العقوبة) بعداً إنسانياً، دأبت القوانين الجزائيّة الحديثة على تبنّيه بفعل تأثير النظريّات الفقهيّة التي ركّزت على شخصيّة المجرم وعلى أسباب جنوحه، وراحت تنظر إليه كشخص مريض اجتماعيا و يحتاج الى علاج لمساعدته على التأقلم مع مجتمعه و احترام القوانين السائدة فيه.
ومن المسلّم به أن بلوغ هذه الغاية يوجب استبعاد كل إجراء أو تدبير تحقيقي وكل عقوبة تمس بسلامة المدّعى عليه الجسدية أو بكرامته و تفضي الى إذلاله أو تحقيره. ويندرج ضمن هذا السياق مبدأ فرديّة العقوبة الذي نادى به العلاّمة ريمون سالاي (1855- 1912) في كتابه “شخصية العقوبة” الصادر عام 1898 (L’Individualisation de la peine ) و قوامه أن يتمّ إنزال العقوبة الملائمة بكل محكوم عليه، بعد الأخذ في عين الاعتبار ظروفه الخاصة و خصائصه النفسية والبيولوجية و الباثولوجية و الاجتماعية وملابسات القضيّة، في ضوء السياسة الجزائيّة التي ارتأى المشترع اعتمادها، و سعياً وراء بلوغ الأهداف المنوّه عنها آنفاً.
بيد أنّ أهداف العقوبة المشار إليها آنفاً تبدو متعارضة؛ إذ انه في حين يتطلّب الردع والتكفير اعتماد عقوبة قاسية و مشدّدة تتناسب مع فداحة الجريمة و الخطورة التي يشكّلها المجرم، و هي تظهر من خلال أهميّة الحق المعتدى عليه و جسامة الضرر الناتج عن الاعتداء و مدى وقع هول الجريمة على المجتمع، يفرض هدف إعادة التأهيل توسّل حدٍ أدنى من الليونة لحمل المحكوم عليه على التجاوب إيجابياً مع التدابير العقابيّة المنزلة به.
وفي خضم هذه المعادلة الجدليّة، تطرح مسألة العقوبات التي تستهدف سلامة المحكوم عليه الجسديّة، و مدى قابليّتها لتحقيق الأهداف المنوّه عنها؛ و إذا كانت العقوبات الجسديّة (كالبتر أو الجلد…) قد اختفت من التشريعات الحديثة إجمالاً، إلاّ أنّ ثمّة عقوبة راديكاليّة هي الإعدام ما زالت معتمدة في العديد من الدول على الرغم ممّا تثيره من جدال و انقسام على الصعيدين الفقهي والتشريعي.
وسنلقي نظرة على ما يطرحه هذا الموضوع على الصعيدين النظري و التطبيقي، وما هو منصوص عليه في القانون اللبناني حوله.
أولاً: على الصعيد النظري:
في المجال النظري الفلسفي أو الفقهي، ثمة نقاش حاد بين أنصار عقوبة الإعدام وبين المناوئين لها، حيث لكل فريق ذرائعه و حججه، و هي تتلخص في ما يلي:
1) الموقف المؤيّد لعقوبة الإعدام :
إن موضوع مدى جواز اعتماد الإعدام كعقوبة، بدأ يطرح في أواخر القرن الثامن عشر (عام 1791 في فرنسا) إلا أنّه حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن ثمة من يناهض جديّا الإعدام كعقوبة مألوفة، أو يناقش شرعيّتها و فوائدها. و قد دافع عن هذه العقوبة مفكّرون وفلاسفة عديدون مثل مونتان (Montaigne) و فولتير(Voltaire) ومونتسكيو(Montesquieu ) و جان جاك روسو …
و يتذرع مؤيّدو عقوبة الإعدام بعدة حجج لتبرير ضرورة الإبقاء على هذه العقوبة، من أهمها:
1. إنّها تسمح بإزالة مجرمين أشرار و خطيرين من الوجود بصورة راديكالية نهائية، فتحمي المجتمع من شرّهم، و من مخاطر تكرار هذه الجرائم، و لا سيما أن موضوع المجرمين المكرّرين يطرح مشكلة عويصة في العديد من الدول.
2. إنها القصاص الوحيد الرادع و العادل في حال ارتكاب بعض الجرائم الشنيعة الرهيبة، وبخاصة أن عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات تسمح بتجنّب العودة الى العدالة الخاصة، لأنّها ترضي ذوي الضحيّة، الذين لولاها لأقدموا على الأخذ بالثأر، ممّا يهدّد بالعودة الى الفوضى وشريعة الغاب و يعرّض حياة العديد من الأبرياء للخطر، كون أعمال الثأر كناية عن دوّامة نارية شديدة الخطورة و متشعّبة النتائج يصعب السيطرة عليها.
3. إنّها قد تكون أقل قسوة من العقوبة الحارمة من الحرّية مؤبّداً.
4. إنه لا يصح تجاهل الأثر الفعّال للإعدام في تأمين الرّدع العام و السيطرة على موجات الإجرام التي قد تستفحل لولا هذه العقوبة، بدليل أنّ دولاً عديدة اضطرّت الى العودة لتطبيق الإعدام بعدما كانت قد ألغت هذه العقوبة بيلاروسيا – الكاميرون – اليابان – المغرب …).
5. إنّ إلغاء عقوبة الإعدام يطرح بجدّية، لا بل بحدّة، مشكلة إيجاد عقوبة بديلة ذات قوة ردع كافية لتحلّ محل الإعدام كجزاء للجرائم الشديدة الخطورة. إذ في بعض الحالات قد يقدم المجرمون على أفعال رهيبة، و لا يكون لديهم ما يخشون منه في حال ألقى القبض عليهم، كمثل حالة المحكوم عليه بعقوبة مؤبّدة الذي يهرب من السجن بعد قتل حارس أو أكثر، ثم يروح فيعيث في المجتمع فساداً، و هو على يقين أنّه في حال اعتقاله مجدّدا لن يصيبه أسوأ ممّا كان عليه حاله قبل هربه…
2) الموقف المناهض للإعدام :
يجيب أصحاب الرأي المعارض للإعدام على حجج المؤيّدين بما خلاصته:
1. إنّ فعالية العقوبة كوسيلة لإزالة المجرمين الخطيرين ليست مطلقة و لا أكيدة، بدليل أن فئة من هؤلاء، و هم المجانين و المعاقين عقليّاً، لن تطالها هذه العقوبة لأنّهم سيستفيدون من مانع إسناد.
2. إنها عقوبة قاسية للغاية، أياً تكن الطريقة المستخدمة من أجل تنفيذها.
3. إنها بعيدة عن المنطق لأنّ المجتمع، عندما ينفذ الإعدام، إنما يقدم على عمل مماثل للفعل الذي سبق له و أدانه عند الحكم على المجرم: و بالتالي هو يقضي على الحياة، في حين يفترض به حماية الحياة.
4. إن الجدوى الفعلية لعقوبة الإعدام غير ثابتة، لأنه في بعض البلدان حيث ألغي الإعدام أظهرت الإحصائيات أنّ نسبة الإجرام لم ترتفع. كما و أنه لا يمكن علميّاً التأكيد على أنّ الإعدام عقوبة رادعة للإجرام، ذلك أنّ التجربة قد أثبتت أنّه لا تأثير للإعدام على المجرمين العنيفين ذوي الأهواء الشديدة … في حين أن هذه العقوبة غير ضرورية و غير مجدية بالنسبة للمجرمين العاديين، لأنّ المجرم الظرفي يمكن أن يرتدع من مجرّد التفكير في أنّه سوف يخضع للتحقيق وللمحاكمة العلنيّة، و لاحتمال دخول السجن …
5. إنها عقوبة نهائية لا مجال للعودة عنها؛ و بالتالي في حال حصول غلط قضائي، يتعذّر تداركه و إصلاح نتائج هذا الغلط لفوات الأوان.
6. وقد لاحظ البعض أيضاً أن عقوبة الإعدام تخلق بلبلة خلال جلسات المحاكمة، حيث تبدو المرافعات و كأنّها صراع مرير بين الادعاء العام و بين الدفاع موضوعه حياة المتهم.
7. إنّ الإعدام عقوبة عفا عليها الزمن فأضحت من الماضي، إذ لا وظيفة لها في إعادة تأهيل المجرم و إعداده ليرجع عنصراً صالحاً في مجتمعه، و هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه التشريعات الجزائية الحديثة.
وفي حصيلة النقاش الفقهي:
يبدو من العسير حسم هذه المعضلة نظراً في ضوء الذرائع المتقابلة. مع العلم أنه لا بد من الإقرار بأن إلغاء الإعدام يطرح مسألتين هامتين:
1- العقوبة البديلة للإعدام،
2- وضرورة ضبط الأمن و النظام في الدولة،
نظراً لوجود علاقة جدليّة بين نسبة قسوة القصاص من جهة و بين نسبة احتمالات إلقاء القبض على المجرم و إخضاعه لأحكام القانون من جهة ثانية؛ فكلّما خفّت النسبة الأخيرة وجب زيادة جسامة القصاص المحتمل، و لو نظريّاً، بحيث تشكل العقوبة القاسية المحتملة سيفاً مسلّطاً على المجرمين المتملّصين من قبضة العدالة، بدلاً من أن تفضي العقوبة المخفّفة الى تقديم خدمة مجانية لهم تتمثل في طمأنتهم إلى مصيرهم في حال القبض عليهم. فإذا كانت الدولة تعاني من ضعف أو مشاكل أمنية و تعجز عن بسط سلطة القانون و تطبيق أحكامه بدقة و جدّية في كل أراضيها، فلا بديل عن التشدّد في العقوبات، و لو نظريّاً، لسد الثغرات في فعالية الملاحقة الجزائية في الواقع.
هذا بالإضافة الى وجود جرائم خطيرة من الصعب إيجاد عقاب رادع لها كبديل عن الإعدام، مثلا:ً قتل حارس السجن أو رجال الأمن؛ أو الخطف و احتجاز رهائن وقتلهم، ولا سيما الأطفال منهم؛ أو الجرائم الإرهابية المستشرية في العديد من المناطق في العالم…
ثانياً: في القانون الوضعي:
لا تزال العقوبات الجسدية مطبّقة في بعض الدول ( الجلد أو بتر أحد الأطراف…) ولكن معظم الأنظمة العقابية الحديثة قد تخلّت عنها بعدما كانت، لفترة خلت، سائدة كقصاص طبيعي ومألوف.
فالقانون الفرنسي القديم كان يعتمدها بكثرة و ينص أحياناً على تعذيب المحكوم عليهم بالإعدام قبل التنفيذ أو خلاله. و جاء قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810 فألغى معظم الممارسات العقابيّة غير الإنسانيّة، بيد أنّه استبقى على بعضها، مثل وشم كتف بعض المحكوم عليهم بالحديد المحمّى لترك علامة تمكّن من التعرّف عليهم لاحقاً، أو بتر اليد اليمنى لمن يقتل والده، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه. و قد ألغي هذان التدبيران بقانون 1832/4/28 .
أمّا الإعدام فقد بقي في القانون الفرنسي الحديث، ينفّذ بالمقصلة (la guillotine) أو رمياً بالرصاص إذا كان الحكم صادراً عن محكمة عسكريّة أو كان الجرم ضد أمن الدولة. وبموجب المرسوم الاشتراعي الصادر في 1939/6/24 أصبح تنفيذ الإعدام في فرنسا يتم في مكان مغلق. و استمرّ الوضع على هذا المنوال حتى صدر قانون 1981/10/9 الذي ألغى عقوبة الإعدام كليّاً (بسعي آنذاك من وزير العدل المحامي روبير بادانتير Badinter Robert)؛
كما ألغت الإعدام كل التشريعات في دول الاتحاد الأوروبي، و لا سيما في زمن السلم… فيما ألغيت في كندا سنة 1976 بعدما كان توقف تنفيذها منذ 1962… وفي أستراليا سنة 1985…
في حين أن عقوبة الإعدام ما زالت معتمدة في روسيا و معظم الدول في آسيا وأفريقيا وعدد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية (27 ولاية – حيث نفذ حكم الإعدام في 25 شخصا سنة 2024)، مع استخدام وسائل مختلفة للتنفيذ…
ثالثاً : الوضع في لبنان:
كان المشترع العثماني قد تأثّر بقانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810 لما أصدر سنة 1858 قانوناً حديثاً للعقوبات، فاستبعد العقوبات الجسدية إجمالاً، لكنه أبقى على عقوبة الإعدام، ونصّ عليها كجزاء لنحو 24 جريمة معظمها ذات طابع سياسي.
وقد ظلّ قانون العقوبات العثماني المذكور معمولاً به في لبنان حتى صدور قانون العقوبات اللبناني (الحالي) و دخوله حيّز التطبيق الفعلي في 1944/10/1؛ و قد استبعد هذا القانون العقوبات الجسدية، و لكنه نص على عقوبة الإعدام.
إنّ الإعدام قصاص شديد ملحوظ لجرائم محدّدة في القانون اللبناني تتسم بخطورة بالغة وتهدّد أمن الدولة العام و السلامة العامة و طمأنينة المواطنين و حياتهم، كما أنها تظهر شخصيّة جرميّة خطرة اعتبرها المشترع غير قابلة للإصلاح.
و قد نصّ قانون العقوبات اللبناني على الإعدام كعقوبة لعدّد من الأفعال الجرمية، من أهمها:
الخيانة { المواد273 فقرة أولى و 274 فقرة (2) و 276 فقرة (2) ق. ع.}
العصيان { المادتان308 فقرة(2) ، و 311 ق.ع. }
الأعمال الإرهابية { المادة 315 فقرة (4) ق.ع. }
جمعيات الأشرار متى أقدمت على قتل أحدهم او تعذيبه او على أعمال بربرية {المادة 336 فقرة (3) ق.ع. }
القتل المقصود المشدّد المنصوص عليه في المادة ( 549 ق.ع.)
أعمال الخطف و حجز الحرية إذا نجم عنها موت إنسان من الرعب او من أي سبب آخر له صلة بالجريمة المذكورة (المادة 569 فقرة أخيرة).
في جرائم الحريق المقصود (المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، و عنوانه ” في الجنايات التي تشكّل خطرا شاملا” ) عند الإقدام على ارتكاب جريمة قتل إنسان قصدا، تمهيدا لجرائم الحريق المنصوص عليها في المواد 587 و 588 و 589 ( المادة 591 ق.ع. )
استعمال مواد متفجّرة من أجل تدمير أو محاولة تدمير أحد الأشياء المذكورة في المواد 587 الى 589 ق.ع. (المادة 592 ق.ع.)
الاعتداءات على سلامة طرق المواصلات والنقل إذا نجم عنها موت إنسان ( المادة 599 ق.ع. )
السرقة الموصوفة المشدّدة المنصوص عليها في المادة 639 ق.ع. إذا أقدم الفاعل خلالها على قتل إنسان لسبب ذات صلة بالسرقة المذكورة ( المادة 640 فقرة ثانية ق.ع.).
جريمة القرصنة المنصوص عليها في المادة 641 إذا أدّت الى غرق السفينة وموت أحد ركابها، أو أدّت الى تدمير منصّة ثابتة و موت أحد ممن عليها { المادة 642 فقرة (2) ق.ع.} .
جريمة خطف الطائرات، او تعريض الملاحة الجوّية للخطر، إذا قام الفاعل بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط أو التدمير، أو إذا نجم عن الفعل موت إنسان (المادة 643 ق.ع.).
كما نصّ على عقوبة الإعدام قانون 11 كانون الثاني 1958 (قانون الإرهاب) الذي علّق بصورة مؤقتة (المادة الأولى) تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات، واستعاض عنها بنصوص أخرى، نصّت معظمها على عقوبة الإعدام، وأناط أمر النظر فيها بالقضاء العسكري (المادة 8):
المادة 2- الاعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض، وإما بالحض على التقتيل والنهب والتخريب.
المادة 3- معاقبة رئيس عصابة مسلحة أو من تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة بعض أملاك جماعة من الآهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة 4- معاقبة المشتركين في عصابة مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين…
المادة 6- معاقبة من يقدم على أي عمل إرهابي… إذا أفضى إلى موت إنسان أو هدم بنيان، بعضه أو كله وفيه إنسان، أو إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
أما في ما يختص بأصول و إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام في لبنان:
وضعت المادة 43 ق.ع. فقرة أولى شرطين أساسيين لتنفيذ عقوبة الإعدام :
1) ضرورة أن يعرض ملف المحكوم عليه على لجنة العفو، المؤلفة في هذه الحالة من كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى العشرة، لإبداء الرأي في إمكانية إبدال عقوبة الإعدام من العقوبة الأقل منها درجة مبدئيا، أي الأشغال الشاقة المؤبّدة، و ذلك بعد أن يحيل وزير العدل الملف إليها. و يكون رأي لجنة العفو المذكورة استشارياً ( المادة 420 أصول جزائية)
2) ثم يحال الملف الى رئيس الجمهورية للموافقة على الحكم. و يكون للرئيس الحق في منح المحكوم عليه العفو الخاص إذا ارتأى ذلك، و هو حق تقليدي معطى لرئيس الدولة في كل الأنظمة السياسية. وفي الحالة المعاكسة يصدر مرسوماً بتنفيذ العقوبة يوقعه رئيس الجمهورية فيصبح الإعدام واجب التنفيذ قانوناً؛ ويوقع أيضاً على مرسوم التنفيذ رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل ووزير الدفاع متى كان الحكم صادرا عن القضاء العسكري، علماً بأن توقيع الأخيرين هو شكلي من أجل اكتمال صيغة المرسوم ولا يحق لأي منهم قانوناً الامتناع عن التوقيع أياً كانت الأسباب، لأن ذلك يخالف مبدأ قوة القضية المحكوم فيها قضائياً ومبدأ فصل السلطات المكرّس في الدستور اللبناني .
وفي حال توقيع مرسوم التنفيذ، لا يصح تنفيذ الإعدام أيام الأحد أو الجمعة أو في الأعياد الوطنية أو الدينيّة {المادة 43 فقرة (2) ق.ع.و المادة 420 فقرة /3 / أصول جزائية}.
كما يؤجّل تنفيذ الحكم بإعدام المرأة الحامل حتى تضع حملها (المادتان43 فقرة/3/ق.ع. 420 فقرة /4 /أصول جزائية ). و هذا التعليق المؤقت للتنفيذ يعتبر تطبيقاً لمبدأ فرديّة المسؤولية الجزائية و شخصيّة العقوبة، و هو يهدف الى إنقاذ حياة كائن بشري بريء هو الجنين الذي سيولد. و قد حدّدت المادة 420 فقرة/ 4/ أصول جزائية مدة عشرة أسابيع بعد الولادة يصار بعدها الى تنفيذ الإعدام.
ومبدئيا لا ينفذ الإعدام ليلا… و جرت العادة أن يتم التنفيذ عند الفجر…
وتنفيذ العقوبة يتم وفقاً للمادة 43 فقرة أولى ق.ع. المعدّلة بقانون 5/2/48 “داخل بناية السجن او في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة “.
و الجملة الأخيرة أضيفت بموجب قانون 48/2/5 المذكور. ذلك أنّه في الأصل كانت اللجنة واضعة مشروع قانون العقوبات قد ارتأت حصر تنفيذ الإعدامات داخل حرم السجن.
وقد أدان القاضي فؤاد عمّون، رئيس اللجنة المذكورة، في تقريره العام حول الإصلاح الجزائي أسلوب تنفيذ الإعدامات الذي كان ينص عليه قانون الجزاء العثماني المعمول به في لبنان حتى 1944/10/1، و الذي كان يقول بعلنيّة التنفيذ شنقاً في الساحة العامة. لأنّ هذه العلنيّة، المفروضة أصلاً لإعطاء العقوبة قوة و مفعولاً رادعين، قد أثبتت التجربة أنها تفضي الى نتيجة معاكسة تماماً للهدف المتوخّى منها، فالمحكوم عليه:
– إمّا كان يتحدّى السلطة و القانون علناً أمام المشنقة… فتنقل الصحافة موقفه وأقواله في اليوم التالي على نحو متعاطف معه، مطرية على مواقفه بعناوين عريضة برّاقة، في حين أنّه أعدم لدفع ثمن عمل إجرامي بغيض اقترفه…
– و إمّا كان ينهار أمام حبل المشنقة، و يصبح منظره مثيراً للشفقة، و أحياناً يفضي إلى الاشمئزاز من هول العقوبة المنفذة فيه.
ومن جهة أخرى رفضت اللجنة المذكورة أيضاً العادة التي كانت تقضي بإعدام المحكوم عليهم الواحد تلو الآخر في حال تعدّدهم؛ و اعتبرت ذلك عملاً بربريّاً أصرّت على إقصائه من تقاليدنا. و لهذه الأسباب نصّت المادة 43 فقرتها الأولى ق.ع. على أنّ الإعدام ينفذ في مكان مغلق.
بيد أن قانون 48/2/5 جاء في مادته الرابعة و أضاف الى الفقرة الأولى المذكورة العبارة المنوّه عنها آنفاً، فهل هذا يعني أنّ الإعدام أصبح من الممكن إجراؤه علناً ؟
إنّ الرأي الراجح في الفقه الجزائي يجيب على هذا السؤال بالنفي، في ضوء الاعتبارات والتحفظات التي أبداها الرئيس فؤاد عمّون، و هو يعتبر أنّ العبارة المضافة بقانون 1948/2/5 تعني: أي مكان آخر مغلق لا يحق للجمهور ولوجه؛ و يكون ذلك عندما لا تتوافر في مبنى السجن حيث يحتجز المحكوم عليه بالإعدام، الشروط الكافية لتنفيذ عمليّة الإعدام في داخله.
ولكن في الواقع نفذت إعدامات عديدة في لبنان في أماكن عامة مع الأسف، و هذا مخالف لروح القانون و لأبسط المبادئ الإنسانية إذ يصبح الموت مشهداً مسرحيّاً و يخوّل الكبير والصغير التفرّج عليه دونما اعتبار أو حرمة للحياة البشرية، فضلاً عن الآثار النفسية السيئة التي قد يحدثها هذا المشهد لدى العديدين، و لا سيما الأطفال.
وفي مطلق الأحوال فقد حدّدت المادة 421 أصول جزائية الأشخاص الذين عليهم حضور تنفيذ الإعدام، وهم:
1) رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، و في حال تعذّر حضوره، قاضٍ يكلفه الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
2) النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أحد معاونيه.
3) قاضٍ من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها محل التنفيذ.
4) كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
5) محامي المحكوم عليه.
6) أحد رجال الدين من طائفة المحكوم عليه.
7) مدير السجن.
8) قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سريّة الدرك التابع له مكان التنفيذ، أو من ينتدبه.
9) طبيب السجن او الطبيب الشرعي في المنطقة.
وفي حال التنفيذ داخل السجن، لا يحق لسوى هؤلاء حضور تنفيذ الإعدام الذي يتم شنقاً، أو رمياً بالرصاص إذا كان الحكم صادراً عن المحكمة العسكرية.
ويسأل القاضي المدني المحكوم عليه إذا كان له ما يروم بيانه قبل إنفاذ الحكم ليدوّن أقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص (المادة 422 أصول جزائية) و ينظم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه رئيس المحكمة، أو نائبه، و المدّعي العام والكاتب. وتعلّق نسخة عن المحضر فور تنظيمه في المحل الذي أجرى فيه التنفيذ و تبقى معلّقة مدة 24 ساعة…و ينسخ الكاتب محضر إنفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة (المادة423 أصول جزائية ). ثم تسلّم جثة المحكوم عليه إلى ذويه ليتم دفنه من دون أي إجراءات احتفالية.
ويحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلّق بالتنفيذ عدا المحضر المبيّن في المادة 423 المنوّه عنها أعلاه تحت طائلة الملاحقة بموجب المادة 420 ق.ع.(المادة 423 أصول جزائيّة). و هذا ما يعزّز الرأي الذي جرى بيانه أعلاه حول ضرورة أن يتم التنفيذ في مكان مغلق بعيداً عن العلانية.
في ختام هذا العرض حول عقوبة الإعدام، ثمة سؤال يطرح نفسه: ما هو مصير هذه العقوبة في لبنان؟ وهل من المستحسن أن يتم إلغاؤها من القانون اللبناني؟ علما بأن ثمة مشروع قانون تقدّم به في 2008/10/10 وزير العدل آنذاك البروفسور إبراهيم نجار، لإلغاء هذه العقوبة… وثمة دعوات كثيرة من جمعيات و أشخاص تحث على إلغائها… فضلا عن كون وضع حكم الإعدام موضع التنفيذ مجمّد واقعيّا في لبنان منذ 2004 ( آخر تنفيذ جرى في 2004/1/17 رمياً بالرصاص في المحكوم عليه ريمي أنطوان زعتر)؟
يلاحظ في هذا المجال أن الأحكام التي تصدر غيابا لا يطرح في معرضها أي مشكل إذ جرت العادة أن تلفظ المحاكم عقوبات مشدّدة في مثل هذه الحالة… علما بأن عقوبة الإعدام المحكوم بها غيابا تسقط بمرور الزمن بعد انصرام مدة 25 عاما تبدأ بالسريان في اليوم التالي لصدور الحكم (المادة 163 ق.ع.)
بيد أن الأمر يختلف بالنسبة للأحكام الصادرة وجاها، حيث القضاة في محاكم الجنايات وغرف محاكم التمييز الجزائية وفي القضاء العسكري وفي المجلس العدلي منقسمون حول موضوع الحكم بعقوبة الإعدام، إذ ثمة من يرفض الحكم بهذه العقوبة أو يمتنع عن الموافقة عليها، فيدوّن مخالفة في الحكم القاضي بالإعدام…
وقد ظهر هذا الواقع جليّا بعدما صدر القانون رقم 302 تاريخ 1994/3/21 الذي أوجب الحكم بإعدام كل من يقتل قصدا، و لو بدافع سياسي أو لسبب سياسي، و منع منح الأسباب التخفيفية التقديرية، وعلّق مفعول المادتين 547 و 548 عقوبات. وكانت الأسباب الموجبة لهذا القانون تتمحور حول الرغبة في ضبط الوضع الأمني المتفلّت بسبب تداعيات الحرب الأهلية التي عانى منها لبنان منذ 1975… و لا سيما بعدما صدر قانون العفو العام رقم 1991/84…وشمل جرائم شديدة الخطورة ارتكبت خلال الحرب الأهلية (من 1975/4/13 وحتى 1991/3/28) – في ضوء الرغبة آنذاك في إسدال الستار على مرحلة مظلمة من تاريخ لبنان وقلب الصفحة و البدء من جديد…
وفي ظل سريان هذا القانون، الذي ألغي في 2001/8/2 بالقانون رقم 2001/338، عبّر بعض القضاة صراحة في الأحكام عن معارضتهم و رفضهم الحكم بالإعدام… في حين تعمّدت بعض المحاكم تأخير الفصل في دعاوى القتل المقصود على أمل إلغاء القانون المذكور في أمد قريب…
من جهة أخرى، ثمة قضاة (وأنا منهم) قد حكموا بالإعدام تطبيقا للنصوص التي تنص على هذه العقوبة، وامتنعوا عن منح المتهمين بجرائم معاقب عليها بالإعدام، ولا سيما القتل المشدّد (المادة 549 ق.ع.) أو الجرائم الإرهابية… الأسباب التخفيفية التقديرية (بموجب المادة 253 عقوبات)، و بخاصة في الدعاوى التي فيها ادعاء شخصي من المتضررين من الجريمة، أو من أنسباء الضحايا المجني عليهم… كما في الجرائم الإرهابية التي عانى منها لبنان منذ سنوات و لا يزال… وكان الحائل دون منح التخفيف يكمن أساساً في الاستحالة المعنوية و الضميرية لتبرير مثل هذا التسامح و التخفيف تجاه ذوي المجني عليهم الضحايا وأولياء الدم، الذين فقدوا أعزاء لهم بنتيجة جرائم واعتداءات شديدة الخطورة لا مجال لإيجاد تبرير لها…
ولا يغيّر في هذا الموقف واقع التوقف عمليا عن وضع عقوبة الإعدام موضع التنفيذ منذ نيّف و 20 سنة، إذ من جهة أولى: يعتبر أولياء المجني عليهم و المتضررين أن حقهم قد حفظ وتمّ تكريسه بالحكم الصادر ولو لم ينفذ…
ومن جهة ثانية نضمن أن المحكوم عليه لن يستفيد من إمكانية تخفيض عقوبته عملا بالقانون رقم 2002/463 (المعدّل بالقانون رقم 2011/183) إلا بعد مرور 35 إلى 40 سنة بعد أن يكون مضى 30 سنة في السجن (المادة 4 فقرة أخيرة). هذا ما لم يصدر قانون عفو عام يشمل حالته…
بيد أن هذا الواقع يختلف عندما يتوصل أطراف الدعوى إلى مصالحة فيسقط المدعون حقوقهم الشخصية، حيث يصبح من واجب القاضي تعزيز هذه المصالحة و عدم نكئ الجراح و “صب الزيت على النار”…
وختاماً:
نرى أن الإجابة على السؤال المطروح آنفا (مدى إمكانية أو مواءمة إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان) ليست بالأمر اليسير إذ إنّه:
إلى جانب الاعتبارات السابق ذكرها المؤيدة للإعدام أو المناهضة له، لا بد من التوقف ملياً عند واقعين حاسمين في هذا المجال:
1- موقف أكثرية الشعب اللبناني عموماً من عقوبة الإعدام…
2 – وحالة النظام القضائي و الأمني في الدولة اللبنانية و مدى القدرة على بسط سلطة القانون وتأمين سلامة المواطنين و أمنهم، و هم في نهاية المطاف الفئة الأولى بالرعاية والحماية.
وطالما أن الروح العشائرية، الميّالة إلى الأخذ بالثأر لدى التعرض للاعتداء، لا تزال قوية ومتجذّرة في النفوس، و طالما أن غالبية اللبنانيين من أنصار مبدأ “العين بالعين والسن بالسن”… والدم مقابل الدم، و الروح مقابل الروح… لا نرى أن ثمة مجالا للتأمل بإمكانية إلغاء عقوبة الإعدام في الأمد المنظور.
وطالما أن الدولة و أجهزتها الأمنية و القضائية عاجزة (أو ممتنعة) عن فرض تطبيق القانون في كل الأراضي اللبنانية بفاعلية، ومع وجود “جزر ومربعات أمنية” عديدة خارج نطاق السيطرة وعاصية على الشرعية، فإنه من العسير، بل من الخطير، التفكير في إلغاء الإعدام، وبالتالي تقديم هدية مجانية إلى العابثين بأمن الناس وحقوقهم، عن طريق طمأنتهم إلى أنه مهما يقترفون من الجرائم لن يتعرضوا إلى أي تهديد جدّي، و لو نظرياً.
لذلك،
وحتى تكوّن غالبية شعبية تناوئ عقوبة الإعدام، و تأنف من فكرة القتل كعقوبة للجرائم… وحتى قيام دولة القانون ذات الباع الطويل القادرة على فرض الأمن والنظام جدّياً و تأمين حماية المواطنين في كل المناطق اللبنانية…
لا نرى أي إمكانية، أو حكمة، أو فائدة في إلغاء عقوبة الإعدام في القوانين اللبنانية.
* القاضي جوزف نخله سماحه، دكتور في الحقوق، رئيس غرفة في محكمة التمييز شرفاً، أستاذ مادة القانون الجزائي في جامعة الحكمة و مادة أصول المحاكمات الجزائية في جامعة القديس يوسف. وقد ألقى هذه المحاضرة ضمن محاضرات التدرّج في نقابة المحامين في بيروت في “بيت المحامي” يوم الأربعاء الواقع فيه 12 شباط 2025 بحضور حشد من المحامين وقدّم له رئيس محاضرات التدرّج عضو مجلس النقابة المحامي إيلي قليموس.
“محكمة” – الخميس في 2025/2/13