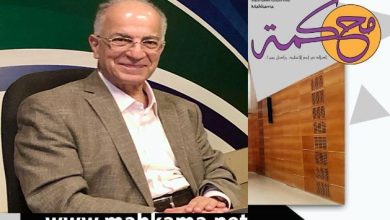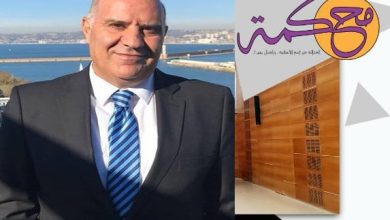البلديات بين نصّ القانون وبدع السياسة/هبة رمضان

المحامية هبة محمّد رمضان:
في قضايا الوطن الأساسيّة لا يصحّ التنظير والخيال، بل معرفة الأمور على حقيقتها وفي أوجه واقعها المعقّد والبسيط، فهيكلية بناء الدولة لا تقتصر على المركزية المتمثلة بالوزارات والإدارات العامة وسياسة الحوكمة فحسب، بل اللامركزية الإدارية الموسّعة التي تضمن حكمَا محليًّا فعّالًا للمدن والبلدات يحقق الانماء المتوازن من خلال تشكيل حكومات مصغّرة مؤلفة من مصالح متخصّصة تعنى بكافة المجالات.
مخاض طويل بانتظار الدولة للوصول الى تطبيق نظام اللامركزية الادارية، لن نتطرّق الى أسباب ودوافع ومعضلات تنفيذها، اذ إنّ واقع غياب دولة القانون والمؤسسات استمر في مشهده حتى بات أمرًا واقعًا يترقّبه المواطنون في كل مرحلة من مراحل الانهيار المؤسساتي الشامل. ومما لا شك فيه ان اللامركزية المعبَر عنها في النصوص والتطبيق يسيران باتجاه معاكس، في حين تعتبر البلديات وما زالت حتى تاريخه، المظهر الوحيد المعبّر عن اللامركزية الإدارية.
البلدية هي الحكم المحلي الممنوح بحكم القانون للمواطنين لإدارة شؤونهم الحياتيّة والاجتماعيّة والعمرانيّة والاقتصاديّة، والتي تخلق من الناحية الاجتماعيّة نوعًا من التّضامن والحياة المشتركة بين أبناء المنطقة المحليّة.
ومع بدء مرحلة المدّ والجزر حول الانتخابات البلدية والتّحالفات السياسيّة، مناسبة نستذكر فيها تاريخ النّظم القانونية للبلديات والممارسات لنسلّط الضوء على أبرز ما أفرزته الممارسات الحزبية السياسية في السنوات الماضية سيما المجالس البلدية المنتخبة في العام 2016 التي تسبق الاستحقاق الحالي المزمع في أيار من العام 2025، وقد برزت مؤخّرًا إتّجاهات سياسية علنيّة لبعض البلديات اللبنانيّة ومنها البقاع الشمالي وبعض كواليس التّحالفات السياسيّة في مناطق عدة الى مداورة الرئاسة بين الأحزاب المتحالفة كما درجت عليها العادة في بلديات 2016.
نتطرّق في هذا المقال الى تبيان طبيعة تلك الممارسة من الناحية القانونية من جهة، والعملية من جهة أخرى وآثارها على فاعلية العمل البلدي وجدواها في ظل نظام بلدي هشّ وديمقراطية مشوبة بداء العنصريّة.
جولة حول النصوص والممارسات
شهد النّظام القانوني للبلديات تحوّلًا خجولًا نحو التّطوير وتعزيز المؤسسات اللامركزية. فمنذ الاستقلال عام 1943 حتى عام 1998 شهد تاريخ البلديات على مدى أكثر من خمس وخمسين سنة غياب، لم تجر الانتخابات الا مرتين عام 1952 وعام 1963 في ظل قانون البلديات رقم 1963/29 وكانت البلديات تعاني من تعقيدات تعرقل سير العمل، الى أن عقد مؤتمر للتطوير البلدي في العام 1964 بهمة الرئيس تقي الدين الصلح – وزير الداخلية آنذاك – تبعه نشاطات ودراسات وأبحاث لتفعيل القطاع البلدي على الصعيد العمراني والاجتماعي والاقتصادي والنهوض في الحياة الديمقراطية.
في منتصف السبعينات، تبلورت الجهود بالمرسوم الاشتراعي رقم 1977/118 حين كانت النوايا السياسية طامحة لتطوير البلديات والى تحقيق لامركزية حقيقيّة وتفعيل المجالس المحليّة.
كرّس المرسوم المذكور مبدأ الديمقراطية بقوة، وللمرة الأولى نصّ على انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس مباشرة من الشعب بموجب المادة 68 منه، وأعطى السلطة التقريرية والتنفيذية صلاحيات واسعة في التقرير بالتّزامن مع جعل سلطة الرقابة محدودة حصرًا بموجب القانون وركّز على آلية الموارد المالية للبلديات من خلال أسس ثابتة ومستمرة لتعزيز حريتها (المادة 86 منه). كما ربط الملاحقات التأديبية بوجه الرئيس بقرارات تصدر عن هيئة قضائية تشكل بمرسوم ويرأسها قاض ويكون عضوَا فيها رئيس بلدية مع رقابة مجلس شورى الدولة على قراراتها (المادة 105 منه)، وجعل آليّة حل المجلس البلدي تتم بموجب مرسوم معلّل يتّخذ في مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس مخالفات هامة متكررة أدت الى الحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية، بالإضافة الى منح البلدية حصانة خاصّة باعتبارها سلطة منتخبة من قبل الشعب.
تلك هي بعض المبادئ التي ارساها المرسوم رقم 1977/118 والتي تصلح اطارًا عامًا لتطبيق اللامركزية الإدارية. بيد أن الممارسات عطّلت تلك النصوص وكان أبرزها اهمال صلاحيّة المجالس البلدية في التّصاميم التوجيهيّة العامّة في المنطقة البلدية وحصرها عمليَا بإبداء الرأي، حتى صدر قانون التنظيم المدني عام 1983 الذي سلب البلدية حقها في التقرير والاكتفاء بدور إبداء الرأي.
بعد تشويه النصوص القانونية بالممارسات السياسية، حاول اتفاق الطّائف تطوير اللامركزية، لكن مع الأسف، كانت بداية رحلة العودة الى المركزية سيّما في مجال الموارد الماليّة والسلطة الرقابيّة المعبّر عنها بسلطة الوصاية، الى ان صدر قانون البلديات والذي كان ولا يزال الإطار القانوني للعمل البلدي منذ عام 1998 حتى يومنا هذا. اذ لم يسلم هذا القانون الأخير أيضَا من التجاوزات رغم قصوره في مجال الإصلاح الإداري وما يستتبع ذلك من عقم في الإنتاجية والفعالية على صعيد الانماء المحلي، ولم يكن يمهّد اطلاقًا لمرحلة مفصليّة في مجال الإدارات البلدية المحليّة.
المداورة في الرئاسة والاستحقاق البلدي الحالي
خلال حقبات الانهيار، لازمت الأحزاب السياسية عملها الدؤوب في المشاركة في الحكم من خلال خوض الانتخابات النيابية والبلدية، وتتكيّف مع التسويات والتحالفات الضامنة لحصصها في المشاركة في السياسة الوطنيّة والمحليّة.
تعتبر الانتخابات البلدية محطة أساسية تتموضع من خلالها الأحزاب السياسية، ومناسبة لها لإجراء استفتاء غير مباشر تلتمس عبره حجم قاعدتها الشعبيّة التي توجّه بوصلة التحالفات والتّسويات في الاستحقاق النيابي الوطني الاوسع، في حين أنه مع الوقت يبلور أكثر فأكثر التأثير المباشر للتحالفات والتفاهمات السياسية بين الأحزاب والقوى على اختيار رئيس البلدية وتحديد سياسته خلال فترة ولايته.
ورغم ضبابية المشهد في ظل الوضع الأمني ومحاولة الحكومة الحالية تنفيذ خطة استعادة الثقة الدولية والوطنية بالدولة ومؤسساتها، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أيار 2025، بدأت الأحزاب والقوى السياسية في تشكيل تحالفات استعدادَا لخوض هذا الاستحقاق.
من جهة، واعترافَا بالمكوّن اللبناني، ان دور الطوائف والأحزاب والعائلات وصراعها قبل وخلال وبعد الانتخابات يجعلنا نرى أن المسار الصحيح لهذا الدور هو حماية البلديات وتنميتها ومساعدتها على النجاح بأداء مهامها، لأنّ البلدية في ما لو نجحت تصبح من المكتسبات الوطنية التي يحرص الناس المعنيون على تنميتها وتطويرها، ولم يحصل حتى الآن ان اخذت البلديات في معظم الوطن حظوظَا كاملة بالنجاح. من جهة أخرى، ورغم الدّعوات لإصلاح النظام البلدي من أجل ضمان الحوكمة المحلية ظهر تنكّر واضح لأحكام قانون البلديات ومزاجيّة سياسيّة في إدارة العمل البلدي عزّزت تأثير السياسة على اختيار الرؤساء والتّقليل من مشاركة المواطنين الفعالة.
لا ننكر ان الحفاظ على التّوازنات في الانتخابات البلدية هي أوليّة ومسعى سياسي ضامن لمشاركة الأحزاب في إدارة العمل البلدي والتمثيل المناطقي. الا أنه لطالما اعتمدت الأحزاب السياسية اللبنانية سلوك التّعالي على أحكام القانون لمصلحة ممارسات واقعية أقرب الى تحقيق مصالحها. وكان من أخطر ما أفرزته التحالفات السياسية هو اقتسام – بالمداورة – فترة ولاية الرئاسة بين مرشحيها ومرشحي الأحزاب المتحالفة في ظل توافق ذو أبعاد سياسية، حيث يتولى كل طرف الرئاسة لفترة محددة بثلاثة سنوات اي نصف مدة الولاية المجلس البلدية.
من منظار سياسي حزبي يبدو هدف هذا الاقتسام مشروعَا اذ يحقق التوازن السياسي بين القوى في مجال الشأن العام البلدي ويضمن تمثيل متساو للأطراف، مع ذلك قد يؤدي الى تحديات ان لم تكن تشوّهات في منظومة العمل البلدي والتي حرص قانون 1977 على تكريسها، جوهر هذه التحديات هي استمرارية المشاريع التنموية وتنسيق السياسات بين الرؤساء.
بالعودة الى النص ان قانون البلديات رقم 665/1997 حدّد مدة ولاية المجلس البلدي بست سنوات، ينتخب المجلس بدوره الرئيس ونائبه من بين الأعضاء، واستحدث نصَا جديدَا يسمح للمجلس البلدي بعد ثلاث سنوات على انتخاب الرئيس ونائبه أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه. وعليه، ان القانون قد أعطى المجلس البلدي المنتخب لمدة ستة سنوات الحق في محاسبة رئيس السلطة التنفيذية أو نائبه من خلال أداة طرح الثقة بالطّرق الديمقراطية.
لا شك أن هذا النص ألهم الفكر السياسي لخلق بدعة اقتسام ولاية الرئاسة، وأصبح بند “المداورة” بالرئاسة من البنود المفصلية على طاولة التسويات والتحالفات رغم وضوح النص.
ان تجاهل التحالفات السياسية بأسلوب المناورة على النص وتعطيل أحكام القانون باقتسام ولاية رئيس السلطة التنفيذية بين الحزبيين أو المتحالفين تعتبر مخالفة صريحة للغاية التي من أجلها وضع النّص وهدفه بالمحاسبة والمساءلة، اذ ان هذه الممارسة هي إرساء لعرف سياسي يعطّل بصورة مقصودة نص القانون للحؤول دون تطبيق وسيلة ديمقراطية ضامنة ممنوحة للمجلس البلدي المنتخب بطرح بالثقة بالرئيس أو نائبه، مما يضعف سبل المساءلة عن فترة إدارة رئيس البلدية للمرفق العام البلدي التي كانت لتتم من خلال حق طرح الثقة بعد ثلاث سنوات من توليه ولايته.
من المنظور العملي، يبدو المشهد مألوفَا سياسيَا، اذ من خلال واقع التّصارع العنصري العائلي من جهة وعدم كفاية الوعي لدى الهيئات الناخبة حول طبيعة العمل البلدي ومفهومه المؤسسي، يظهر التحالف السياسي بدوره المنقذ الأفضل لفرض قوى ترشيحية قد تحظى بأكثرية توافقيّة، وهذا ما يتم فعليَا ترويجه كنوع من أنواع التسويق السياسي لمبدأ السعي للتّفاهم والانسجام في إدارة العمل البلدي كبديل عن التّناحر والتّعطيل الغير المسؤول للإدارة البلدية.
من هنا، لا شك أن للبلدية وظيفة أساسية نادرًا ما تذكر أو يشار اليها الا على سبيل نفيها أو انكارها، وهي الوظيفة السياسية رغم تأكيد الأحزاب والمحللين السياسيين أن دور البلدية تنموي.
أما التّحدي العملي الأهم لبدعة المداورة، فهو عدم الاستقرار الإداري، اذ بالعودة الى روحية نص المادة 11 الذي حدّدت مدة ولاية المجلس البلدي بست سنوات ورئيسه المنتحب لمدة مماثلة أيضَا، غايتها في جعل مدة الولاية طويلة نسبيَا تعود لطبيعة العمل البلدي التي تستلزم تخطيطًا وتنفيذًا لمشاريع إنمائية في كافة المجالات، وتحفيزَا للمجلس البلدي ورئيس السلطة التنفيذية لإدارة مشاريع إنمائية تصبّ في النّفع العام الذي يتطلب مراحل إدارية وفنية تبدأ بالتّخطيط وتخضع للموافقات من قبل السلطات الرّقابية حسب طبيعتها وتمرّ بمرحلة التّمويل والتّنفيذ الذي قد يستمر لأكثر من ثلاث سنوات.
مما يعني واقعيَا، تقصير مدة ولاية الرئيس كسلطة تنفيذية في مجلس بلدي يفتقد غالبَا للرؤية الجامعة هو تعطيل لتنفيذ المشاريع الطويلة الأجل الذي ينعكس على فعالية استمرارية المشاريع والخدمات مما يؤثر حكمَا على التّنمية المحلية والفشل الذي تعايشت معه معظم البلديات على مرّ السنوات.
والتّحدي الآخر يتجلى بضعف المساءلة من خلال تشتت المسؤولية وصعوبة محاسبة الجهات المعنيّة عن أدائها من خلال خلق حالة من الارباك المؤسساتي سيما في البلديات ذات الوسائل البدائية في الهيكلة والتنظيم كما السواد الأعظم من البلديات.
هذا فضلاَ عن أن عرف اقتسام الولاية الرئاسية وان كان يوفر استقرارًا سياسيًا في المجالس البلدية، الا أنه يؤدي الى تهميش دور المواطنين في اختيار ممثليهم المحليين خاصة إذا كانت التعيينات تتم بناء على اعتبارات سياسية بحتة.
وأمام الاستحقاق القريب، وفي ظل السعي لتأمين التوازنات السياسية، قد نكون أمام مستقبل عنوانه العريض مشاريع قيد التنفيذ في أحسن الأحوال، لا سيما وأن تلك المشاريع تتطلب استمرارية حتميّة وتنسيقًا طويل الأمد، وما أظهره واقع العمل البلدي منذ عام 1998 أن فترة الولاية الرئاسية المقتسمة بالمداورة تشكل صعوبة في متابعة أي المشروع وضمان استدامته.
إنّ تطوير الإدارة البلدية ضرورة تستلزم التغيير المؤسسي في الهيكلية الإدارية للبلديات، وذلك من خلال عصرنة إدارة القرى وتحسين الإنتاجية التي تبدو وكأنها ترتبط بتنفيذ وتطبيق القانون، الا أنها تكمن في تجاوب المواطنين مع مشاريع التنمية كافة.
فلتتجه بوصلة الأحزاب السياسية نحو خطة إنمائيّة قصيرة وطويلة الأجل تجدول زمنيَا مراحل تنفيذ أي مشروع انمائي يشرك المواطنين وفق خطة واضحة وشفافة عوضًا عن ابداعها في التّقسيم الزّمني لولاية الرئيس وفق مقاييس المصلحة الحزبيّة دون المصلحة العامة المحليّة. وحبّذا لو يكون تحقيق التّوازن السياسي بين القوى وضمان التّمثيل بنيته دولة القانون والمؤسسات ووجهته التّخلي عن بدع السياسة التي تفرغ النّصوص من محتواها في دولة منهكة بالتعطيل ومغيّبة فيها سبل المساءلة والمحاسبة.
فالوعي لا تاريخ محدّد له حين يكون الاستدراك نتيجة للوعي، وليس حصيلة للتقصير وحسب.
“محكمة” – السبت في 2025/4/5